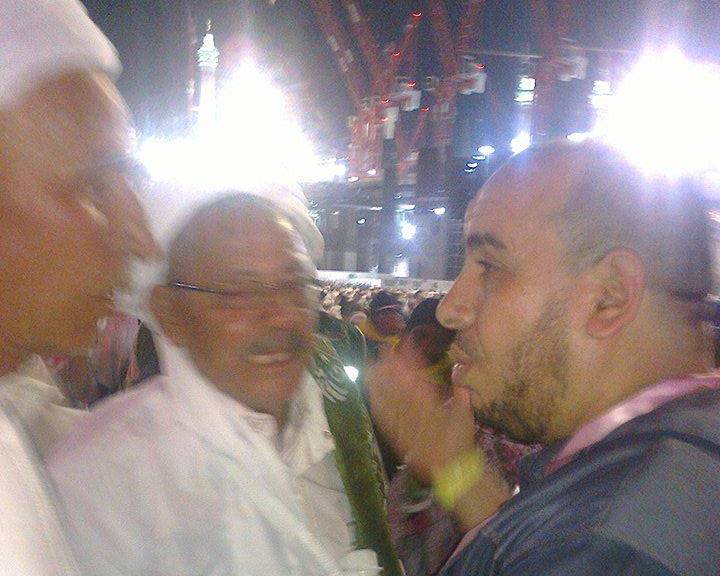
رحلة إلى بلاد الحرمين (12) بقلم الأستاذ حسن تلموت
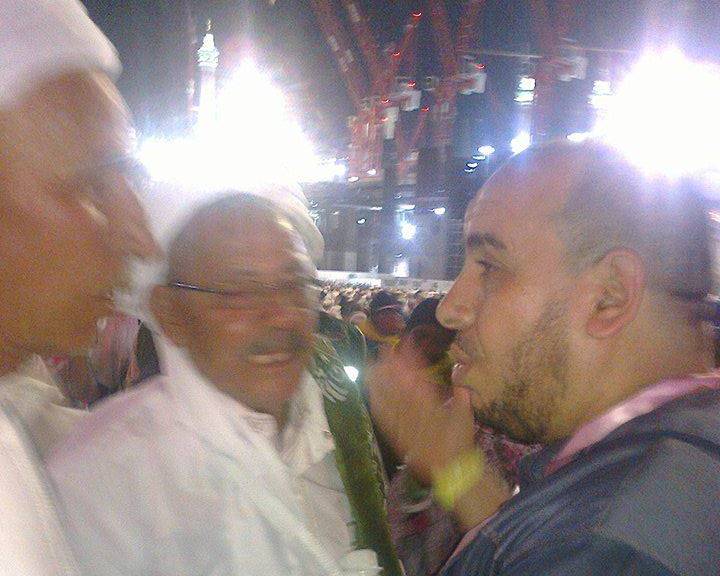
الحج مؤتمر إسلامي عالمي
الجزء الأول:
حوار مع حبيب من الجزائر
ظللنا نحرص على الصلاة في المسجد الحرام ما تيسر لنا ذلك -وقد كان متيسرا ولله الحمد والمنة- ذلك أن الفندق الذي حجزت لنا فيه “وكالتنا” كان محاديا للحرم المكي، إذ كانت صفوف المصلين تمتد حتى تجاوز أبوابه.
فترة الصلوات –خصوصا داخل الحرم- من الفترات التي يتم فيها –كثيرا- الحوار الأفقي بين الحجاج عموما، فأنت تجلس في مكانك فتسمع هذا يبادرك بالسؤال:
-السلام عليكم، “الأخ من المغرب؟”
طبعا يعرف الحجاج انتماءات بعضهم البعض من البطاقة المعلقة على رقابهم والتي تظهر فيها أعلام بلادهم كبيرة أحيانا، وأحيانا أخرى من ألبسة خاصة تحوي أسماء أو أعلام أو خرائط…تدل على بلدانهم وأصولهم..
وقد تبادر أنت بالسؤال، لتحس أن الفرق بينك وبين غيرك من المسلمين ليس فرقا كبيرا، بل إن غير العرب من الحجاج لا تعدم طريقة للتواصل معهم، إما بالابتسامة وما أعظمها من وسيلة تواصل وتعبير عن الخوالج ومعاني الأخوة الدافقة، بل لعلها العبارة الوحيدة التي تنتمي إلى لغة راقية لا تُضمَّن إلا الصافي من المشاعر، والواضح من الأفكار…
جئت إلى المصلى فوجدت سجادة الحاج الذي سبقني إلى الصف فارغة، إذ أنه جلس على سجادة سابقه ينتظر الصلاة، وقد كان موقفي هو تمام الصف، فلم يعد للقادم متسع ليصلي فيه وإلا دخل في ممر السيارات. نظرت أمامي فإذا “الحاج” الأفغاني، أو الباكستاني، العظيم البنية يجلس في الصف الذي أمامي مفترشا الثرى، ربتت على كتفه فالتفت، سلمته السجادة ليجلس عليها انتظارا للصلاة، تهللت أساريره وهو يتناولها، معبرا بقسمات وجهه عن امتنان كبير…ثم وضعها على الأرض، ثم جلس..انشغلت عنه ببعض ما ينشغل به الحديث عهد بالمكان، من النظر إلى البنايات وغيرها، ثم حانت مني التفاتة إليه فإذا هم واضع السجادة تحت رجليه، مستمر في افتراش التراب!!! لم يشغلني ذلك كثيرا إذ القصد أن أحارب شيئا من الأثرة جبلت عليها النفس البشرية، أما فعل هذا الحاج فقد نسبته إلى ما ألف من بيئته، ولعل الصلاة على الثرى أريح له، لكن الذي أثارني هو رد فعله بعد الصلاة، فقد ظل يتمتم بعبارات لم أفهم منها واحدة، سوى أن ابتسامته وإشراقة وجهه كانت رسولا بيننا تنبئانني أن المودة موصولة بيننا بالسجادة وبدونها…
لكن الحجاج العرب كانت اللغة مركبا سهلا متوسلا به إلى معرفة أوضاع بلادهم، وإلى الانسياب مع أحلامهم…
بعد صلاة العشاء قمت لأتمشى مع زوجتي في جنبات البيت الحرام…
شيخ معمم، لكنها عمامة الجدود الأقرب إلى “الفطرية” والأبعد عن شكل “عمائم التكلف” التي صار الشباب يفقدون بها هوياتهم الخاصة اليوم، بل يهربون بها إلى وهم الانتماء إلى بلدان يضمرون في خواطرهم أنها المرجع…فترى الشاب لا يحس أنه أخذ بطاقة عضوية في نادي “الكبار” إلا إذا عقد العمامة، أو وضع قطعة الثوب على رأسه بالشكل الذي توضع به في بلاد معينة، وللهرب من سؤال الأصالة، والانتماء، وإرث الجدود…ينسب طريقة اللباس إلى نسب هي منه براء، ولا علاقة لها به إلا علاقة الإٍرث التاريخي!!!…حتى أني التقيت من قال لي ذات يوم:
“أتدري ما لباس التقوى الوارد في الآية الكريمة؟؟ إنه…
ثم أحالني على لباس خليجي معروف، وعلى طريقة لباس خاصة!!! والبئيس لا يعلم أن اللباس والطريقة في لبسه لم يملها سوى قساوة الظروف الجوية التي يعيشها هؤلاء القوم، أما الآية الكريمة فهي منها براء!!!
التفتت إلى الحاج المعمم، ولما لمح راية المغرب على صدري، أقبل علي ضاحكا، وهو يصرخ :”أهلا ب “خاوتي”…
لم يكن شابا حدثا، ولا يُحس منه إرادة التكلف، ولا رجلا يُفهم من رد فعله هذا صناعة متسمة بالدبلوماسية…بل هي الفطرة اندفعت، والصدق تدفق، والمحبة فاضت…
عربيته “الدارجة” شابهت دارجتنا العربية…لم يمهلني بل ضمني في حضن أحسست معه الدفئ والصدق…
تابع في انسياب عجيب “فرقتنا يا حبيبي السياسة…” ثم أردف بسرعة :”للساسة حساباتهم، ولنا شعوبا مسلمة حساباتنا…”
حاولت أن أتكلم وقد بهرني المظهر والمشهد برمته، لكن “حبيبي” الجزائري لم يمهلني، وكأن فيضان المشاعر الصادقة الدافق يريد أن يعبر بسيله مرة واحدة قبل أن يصل جميعه إلى مصبه في قلبي…ثم يتوقف ليرى أثره ونِتاجه:
-اتدري؟ لقد كنت في مدينة (…) في الجزائر، في إحدى ليالي شهر “ماي” سنة 2003 للميلاد، حين تفاجأت بالناس وقد زينوا الحي الذي نسكنه، لم ألتفت للأمر كثيرا، بل ظننته حالة فرح عند إخوني المغاربة الذين يشكلون غالبية السكان هناك، واستعددت لاستقبال الدعوة بعد عودتي من العمل، لأجيبها دون تردد، وبالفعل ثبت لي أن الأمر أمر فرح مغربي، لكن الذي لم يحصل هو “الدعوة” التي كنت انتظرها، إذ أنني سمعت صوت الجلبة والزغاريد والدفوف في الحي بعد المغرب، فعلمت بعد الاستطلاع أن “ولي عهد المملكة المغربية” قد رأى النور، فعلمت حينها أن المغاربة يحبون ملكهم حق الحب، وتمنيت لو كانت علاقة الحب هذه بين كل الحكام المسلمين وشعوبهم…
كان كلاما في السياسة والاجتماع، والتاريخ، والفقه…لكن الأعظم الدال على الصدق هو العبرات التي انسابت من عينيه وهو يعبر بسرعة عما جاش في خاطره.!!!
عبرات لا كالعبرات، ودموع لا كالدموع، ساخنة سخونة المشاعر المرافقة، ختم المرافعة الصادقة المخضبة بالدموع الصادقة، بالدعاء الخاشع:
-أسأل الله العظيم أن لا يفرق بيننا، إخوانا متحابين فيه..”
ألجمني فعله وكلامه، ودموعه، فلم أحر جوابا سوى أنني تلقيت “ضمته” بالتأثر عانقته معانقة لم أكن أحب أن تنتهي…
رجل في عمر والدي، لا يبدو عليه أمارات الثقافة، والفلسفة، والحداقة، والسياسة….الذي يبدو عليه هو القدرة على نقل المشاعر كماهي، بغير تكلف…
ايقظنا من فرحة اللقاء وشجون الكلمات، صوت يقول:
-أنتم الجزائريو لا تحبوننا وملكنا –حفظه الله-……
-لم أتمكن من سماع باقي كلمات المداخلة غير أنني فهمت ان السيدة “المغربية” المصونة التي ترافقنا –وهي امرأة طيبة الأخلاق على ما خبرت- لكنها انزاحت إلى خيار الغيرة المفرطة على وطنها…
فقد ذكرت لي فيما بعد أن حديث صاحبي عن –تفريق الحكام والسياسة لنا- استفز مشاعرها الانتمائية، فنفرت للدفاع عن ملكنا/حاكمنا الغالي!!!
تدخل الرجل المرافق لمحدِّثي برد عنيف على كلام صاحبتنا، قائلا:
-بل أنتم المغاربة من فعلتم…..
كان كلام الأولى غير العالم، ورد الثاني غير المؤسس، نفخة في رماد أثار زوبعة آنية من الاستغراب، لكنها سرعان ما انقشعت، وأنا أقول لصاحبي، وقد تجاهلنا الخطابات الانفعالية المستهجنة:
-أقسم بالله أن ما يجمعنا هو الأصل، وما يشغلنا من هموم لا يرقى أبدا لأن يفرقنا…
وانأ أحاور صاحبي، ساح بي الفكر إلى سنوات قليلة فارطة حين التقيت في مؤتمر علمي، في “تركيا” مع باحثين شباب من مختلف بلاد المسلمين متوقدين حيوية ونشاطا..
ذكرت أن مختلف الباحثين كان يتطلب التواصل معهم –على حلاوته- شيئا من مراكب العنت في الكلام، إذ كنت أحرص على الحديث باللغة العربية الفصيحة لتجنب الوقوع في حالة الافتتان بدارجة الآخرين، وبالتالي فقدان عنصر “الخصوصية” المغني لمكونات الذات الجمعية “العربية المسلمة”.
لم أكن أشعر بالراحة في الحديث إلا مع “الجزائريين” خصوصا، لأن دارجتنا متقاربة، فكنا نبلغ الرسائل بيننا بعفوية صارخة…
ذكرت أيضا “هشام…” و”نور الدين”..و”معمر”… وغير هؤلاء.. حبل الود باق بيننا، لا يفرقه شيء بحول الله مادامت السماوات والأرض، فقط لأننا “واحد” مش “اثنين”…
مضى صاحبي..التهمه الزحام وهو يحث الخطى نحو “المسجد الحرام” يلتفت فيودعنا، نبادله الابتسامة بأختها، نخبره أنه:
” كانت اللقيا بيننا –فرادى- في بيت الله..حجا، وسيكون تجديد العهد بيننا –فرادى- في جنان الخلد بحول الله.
أما “جمعا” فنحن “جسم واحد” ولسنا “جسمين اثنين”.














